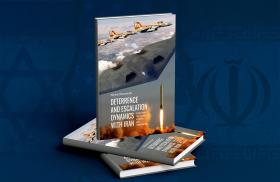- تحليل السياسات
- منتدى فكرة
إطار عمل صندوق النقد الدولي للبنان: الموازنة بين ديون الدولة وحقوق المودعين

قد تؤدي المقترحات المطروحة حتى الآن أمام مصرف لبنان إلى إطالة أمد الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، بدلاً من المساهمة في معالجتها.
في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها لبنان في مجال الانتعاش الاقتصادي والمالي بعد الانهيار الاقتصاد الذى شهده عام 2019، لا تزال هناك قضيتان مترابطتان تثيران جدلا واسعا: استعادة أموال المودعين الذين حُرموا من الوصول إلى ودائعهم المصرفية، ومحاسبة المسؤولين عن تبديدها. في هذا السياق، يُصر كثيرون على تحميل القطاع المصرفي وحده المسؤولية، ما يعفي المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين من تورطهم في عملية الاحتيال على أصحاب الحسابات. وهذه الرواية يفضلها "حزب الله" وحلفائه، الذين وفروا الغطاء السياسي لثقافة الفساد التي أدت في النهاية إلى الانهيار الاقتصادي.
تتفاوض الحكومة الجديدة حالياً مع صندوق النقد الدولي على حزمة إصلاحات شاملة، وهي خطوة تمثل فرصة حقيقية لمحاسبة المسؤولين والسياسيين. لكن المفاوضات لا تسير على ما يبدو في الاتجاه الصحيح. فبدلاً من إيلاء الأولوية للمساءلة، يركز صندوق النقد الدولي - كغيره من المقرضين الدوليين - بشكل أساسي على تقليص مديونية عميله المحتمل، أي الدولة اللبنانية، حتى وان كان ذلك على حساب المودعين والبنك المركزي.
جمود حول استغلال أصول الدولة
هناك اقتراح يتداول في أروقة السلطة في بيروت ويشكل محور جدل واسع، يتمثل في بيع جزء من احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان والبنك المركزي اللبناني. وقد ركز صانعو القرار على هذه الاحتياطيات بعدما تحول الذهب، بفعل ارتفاع أسعاره، إلى الأصل الأقوى أداءً في محفظة البنك المركزي. ومع ذلك، تبلغ قيمة هذه الاحتياطيات حالياً نحو 33 مليار دولار، في حين تصل ديون البنك الإجمالية إلى 80 مليار دولار. ويثير اقتراح صندوق النقد الدولي بإجبار البنك المركزي اللبناني على تسييل جزء من احتياطاته من الذهب جدلاً واسعاً، إذ تُعتبر هذه الأصول على نطاق واسع ملكاً للبنك المركزي والمودعين، لا للدولة اللبنانية نفسها. ويؤكد عدد من النواب الذين التقوا بمسؤولي صندوق النقد أن الأخير أوصى الحكومة اللبنانية بأن تتوقف عن سداد ديونها البالغة 16.5 مليار دولار للبنك المركزي، وهو مبلغ خصصه المصرف مباشرة لسداد الودائع. ويُفهم من هذا أن الهدف لا يتمثل في تعزيز مالية الدولة لصالح المودعين أو الاقتصاد، بل في إضعاف ملف ديون لبنان بما يكفي لتأمين قروض جديدة من الصندوق، وتقليل المخاطر المترتبة عليه.
وتهدد تداعيات هذا الاقتراح بتقويض الركائز الثلاث الأساسية للبنية المالية اللبنانية: البنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين العاديين. يعمل مصرف لبنان بصفته البنك المركزي كسلطة نقدية مسؤولة عن إصدار الليرة اللبنانية وإدارة أسعار الفائدة وتثبيت سعر الصرف (تاريخياً من خلال ربط العملة). تقوم البنوك التجارية في الوقت نفسه بتوجيه المدخرات المحلية ومدخرات المغتربين اللبنانيين إلى الاقتصاد من خلال جمع الودائع وتقديم القروض للشركات والأسر والحكومة.
إلى جانب ذلك، تستقطب البنوك مليارات الدولارات من الودائع بالعملة الأجنبية التي تُستخدم في تمويل العجز التجاري المستمر في لبنان واحتياجات القطاع العام. كما تلعب دوراً محورياً في تمويل الدولة عبر شراء كميات كبيرة من السندات الحكومية وإيداع الأموال في البنك المركزي، ما يجعلها عملياً الدائن الرئيسي للحكومة. وتُعد ثقة المودعين في هذه البنوك حجر الأساس لاستمرار النظام المالي. فإذا أقدموا على سحب أموالهم أو توقفوا عن إرسال التحويلات، سيتعرض النظام بأكمله لأزمة سيولة خانقة. فمن الجدير بالذكر أن ودائع المواطنين اللبنانيين في الداخل وأبناء الجالية في الخارج هي التي تُمكّن البنوك من إقراض الاقتصاد والدولة، وبالتالي يعتمد النموذج المالي اللبناني بشكل جوهري على التدفقات المستمرة. إذا عجزت الحكومة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها وألقت بأعباء ديونها البالغة 16.5 مليار دولار على كاهل البنوك التجارية والمودعين، سيصبح انهيار القطاع المصرفي التجاري شبه مؤكد.
تكمن خطورة نهج صندوق النقد الدولي في أنه لا يقتصر على تكريس حالة الشلل التي يعاني منها القطاع المصرفي الرسمي فحسب، بل يتعداها إلى تعزيز هيمنة الاقتصاد النقدي في لبنان – وهو نظام ظل مالي يخضع إلى حد كبير لما يُعرف بـ "الثنائي الشيعي"، أي "حركة أمل" و"حزب الله". ومع حرمان المودعين من الوصول إلى حساباتهم وشلل البنوك عملياً، أصبحت المعاملات النقدية هي السائدة في السوق، مما يمنح هذه الجماعات نفوذاً أوسع على التجارة والضرائب وتبادل العملات. ويحذر اقتصاديون من أن هذا الوضع يرسّخ الفساد، ويقوّي هياكل السلطة الموازية، ويُضعف أي إمكانية للعودة إلى منظومة الحوكمة الاقتصادية الرسمية.
ومع اقتراب البلاد من الاستحقاقات الانتخابية المقررة في العام المقبل، يُتوقع أن يزداد النقاش احتداماً داخل البرلمان. ولم يعد الجدل منصباً على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي بحد ذاتها – التي كان البنك المركزي قد قدّم خطوطها العريضة بالفعل، بما في ذلك شطب المطالبات غير النظامية من ميزانيته العمومية والالتزام بسداد الودائع نقداً أو عبر أوراق مالية. السؤال الجوهري اليوم هو: من سيتحمل تكلفة إعادة الهيكلة؟ ومن سيمول الانتعاش الاقتصادي؟ ويبدو أن صندوق النقد الدولي يدفع نحو نموذج لا تتحمل فيه الدولة - بصفتها المدين المحتمل - أي مسؤولية عن السياسات السابقة، بينما يُترك عبء التنظيف للبنك المركزي والبنوك التجارية، وفي نهاية المطاف للمودعين.
سد الفجوة
إن الشعور بعودة التاريخ في لبنان واضح للعيان، إذ يُستحضر أزمة المصارف عام 2020، حين تسبب سوء الإدارة وإفراط القطاع العام في الإنفاق بخسائر قُدرت بنحو 100 مليار دولار. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يُحاسَب أي مسؤول حكومي على ما يُعتبر سرقةً مقننة لأموال المودعين، الذين أُجبروا عملياً على إقراض الدولة. ولا يزال هذا الأمر حاضراً بقوة في ذاكرة اللبنانيين. علاوة على ذلك، فإن احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان محمية بموجب القانون رقم 42/1986، الذي يشترط إصدار تشريع برلماني للموافقة على أي عملية بيع. وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة اللبنانية ستقبل الاقتراح أو سيخضع البنك المركزي اللبناني لضغوط صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة لا تزال ملزمة بموجب المادة 113 من قانون النقد والائتمان بتعويض أي عجز في البنك المركزي اللبناني. وبحسب ما ورد، فإن الحكومة، بموجب المادة 113، مدينة بمبلغ 14.9 مليار دولار بالإضافة إلى 16.5 مليار دولار مستحقة بالفعل للبنك المركزي اللبناني. لذلك، يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطاً على وزارة المالية اللبنانية لعدم الاعتراف بهذه الديون، في الوقت الذي يضغط فيه أيضاً على المصرف المركزي لبيع جزء من احتياطاته الذهبية، في مخالفة واضحة للقانون اللبناني. وقد قدم مصرف لبنان لصندوق النقد أدلة تثبت أن هذه الديون ناشئة عن قروض حصلت عليها الحكومة، غير أن الصندوق رفض قبولها.
ولتعويض الفجوة، سعى البنك المركزي اللبناني إلى إيجاد بدائل لا تضطره إلى بيع احتياطاته من الذهب. ومن بين هذه المقترحات ما يُعرف بـ " تعظيم الاستفادة" من احتياطيات الذهب، من خلال إيجاد وسائل لتوليد دخل منها من دون بيعها. ويقوم هذا الطرح على رقمنة الذهب – عبر ترميزه أو تحويله إلى عملة مستقرة – ثم تأجيره مع الاحتفاظ بالملكية. وبحسب التقديرات، فإن استثمار ما يعادل 1% من احتياطيات الذهب، التي تتجاوز قيمتها 33 مليار دولار، يمكن أن يدر نحو 350 مليون دولار، ما يساعد في توفير السيولة اللازمة لتعويض المودعين. وفي مقترح منفصل، عرض المصرف المركزي قبول سداد الحكومة ديونها البالغة 16.5 مليار دولار على شكل سندات دائمة بفائدة 2%، إضافة إلى عائدات أي عمليات خصخصة مستقبلية. وكان من شأن هذه الآلية أن تُخفف من عبء استدامة الدين العام، الذي طالما اعتبره صندوق النقد الدولي مصدر قلقه الرئيسي في سياق إقراض لبنان. ومع ذلك، بقي صندوق النقد الدولي متمسكاً بموقفه المتشدد.
ومع ذلك، توجد وسائل أخرى يمكن للدولة اللبنانية من خلالها سداد ديونها من دون الإضرار بالنظام المالي الداخلي. فعلى سبيل المثال، قد تمثل خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان مدخلاً إلى فوائد اقتصادية ومالية كبيرة، في وقت تعصف بالبلاد أزمة مالية خانقة. لطالما تعرضت شركات الاتصالات المملوكة للدولة لانتقادات حادة بسبب ضعف الكفاءة وارتفاع الأسعار وسوء الخدمات، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التدخلات السياسية المزمنة وضعف الاستثمار في البنية التحتية. ومن شأن الخصخصة أن تستقطب رؤوس أموال أجنبية ومحلية، بما يتيح تحديث الشبكات وتعزيز موثوقية الخدمات. كما ستُخفف من الضغط على المالية العامة عبر تقليص الخسائر التشغيلية وتوليد إيرادات فورية من بيع الأصول – وهي أموال يمكن توجيهها إلى خفض الديون أو دعم برامج الإنفاق الاجتماعي. إلى جانب ذلك، فإن فتح قطاع الاتصالات أمام المنافسة قد يسهم في خفض التكاليف على المستهلكين والشركات، وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية، ودعم النمو الاقتصادي على نطاق أوسع. وبالنسبة إلى لبنان، حيث شكلت عائدات الاتصالات تاريخياً مصدراً رئيسياً لدخل الحكومة، يمكن أن تؤدي الخصخصة إلى تحويل النموذج من تحصيل الإيجارات إلى التنمية المدفوعة بالابتكار.
يمكن للدولة اللبنانية أيضاً أن تسعى إلى زيادة إيراداتها من خلال تحديث نظام تحصيل الرسوم الجمركية. فعلى الرغم من التحسينات التي أُدخلت مؤخراً، لا تزال الإدارة الجمركية تعاني من تحديات خطيرة. فالتلاعب بالفواتير، وانتشار الرشوة، والمعاملة التفضيلية التي تتيح مرور العديد من البضائع من دون دفع كامل الضرائب، ما زالت ممارسات شائعة، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في إيرادات الدولة. علاوة على ذلك، فإن النظام الحالي مجزأ ومتقادم، إذ تؤدي التدخلات السياسية وشبكات المحسوبية إلى إضعاف آليات الإنفاذ. وفي كثير من الأحيان تمارس جماعات سياسية أو طائفية نفوذها على الموانئ والمعابر الحدودية، مما يقوّض مبدأ التطبيق الموحد للقانون.
المضي قدماً
بدلاً من إعفاء الحكومة من مسؤوليتها عن الأزمة المالية في لبنان وإلقاء عبء الخسائر على المودعين، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يمنح المؤسسات اللبنانية فرصة لمعالجة أزمة ديونها بنفسها. ومن ثم، يتعين على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية التوصل إلى حل وسط يُعطي الأولوية لسداد المطالبات العادية (أي الودائع المشروعة)، وذلك بعد شطب المطالبات غير النظامية من ميزانيات المصارف. وقد استعانت هذه المؤسسات فعلاً، بمستشارين ذوي خبرة ولديهم سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال. بعد ذلك، يمكن لصندوق النقد الدولي الدخول في مناقشات حول اتفاق على مستوى الموظفين مع الدولة اللبنانية، يرتكز على الانضباط المالي وإعادة هيكلة المالية العامة، على غرار الاستراتيجية التي اتبعها في الأرجنتين.
في الوقت الراهن، يبدو أن المصرف المركزي يمارس قدراً من ضبط النفس، ويدخل في مفاوضات حساسة مع الحكومة وصندوق النقد الدولي. لكن صبر اللبنانيين الذين حُرموا من ودائعهم بدأ ينفد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. وإذا فرض صندوق النقد الدولي مثل هذه الخطة على الحكومة اللبنانية، فسيكون الثمن القضاء على أموال المودعين، وربما إطلاق رد فعل شعبوي يتحول إلى احتجاجات جماهيرية. وقد تؤدي الاضطرابات الواسعة إلى زعزعة الاستقرار السياسي الهش في لبنان، وإلى شلل يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة. ويشير المراقبون إلى أن ضعف الحكومة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الاستقرار والإصلاح الذي يدعي صندوق النقد الدولي أنه يدعمهما.