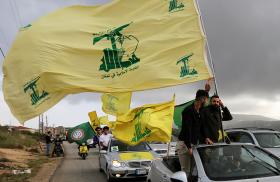تطهير ما بعد البعث في سوريا: عدالة انتقالية أم محفز للانقسام؟

على الرغم من ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في ظل نظام الأسد، فإن حملات التطهير الواسعة التي تطال موظفي القطاع العام تهدد بتعميق الانقسامات في بلدٍ يعاني أصلاً من التشرذم والتفكك.
منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، شهدت سوريا حملات تطهير واسعة استهدفت موظفي القطاع العام. ومن المتوقع أن تُفضى خطط إعادة الهيكلة الاقتصادية إلى إقالة ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف موظف من المؤسسات الحكومية، مما
يفاقم معدل البطالة المرتفع أصلاً والذي يتجاوز 60%. وقد جرت إقالة العديد من الموظفين فعلياً رغم غياب معايير قانونية واضحة أو منهجية لإجراءات الإقالة. في حين يمثل إصلاح شؤون الموظفين عنصراً ضرورياً في أي عملية انتقالية ذات مصداقية، فإن عمليات الإقالة الجماعية التي تتم في غياب الحوار الوطني، وفي ظل انعدام ضمانات تحول دون العقاب الجماعي، أو تكفل الاندماج في المستقبل، تنطوي على خطر تعميق الانقسامات بدلاً من إرساء بناء وطني جديد. إن الاعتقاد السائد باستهداف جماعات دينية بعينها في سوريا، في وقت تتغاضى فيه السلطات عن محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إبان عهد الأسد، يغذي مناخاً من الثأر ويشجع على تسوية المظالم الممتدة من زمن الحرب خارج إطار القضاء، وغالباً بوسائل عنيفة.
إن التوتر بين الإصلاح والاستقرار ليس أمراً جديداً في البلدان التي تمر بتحولات جذرية في أنظمتها السياسية، وتشكل تجربة إزالة البعثيين في العراق بعد الاحتلال عبرةً واضحةً لسوريا اليوم. ففي الأيام الأولى عقب سقوط نظام صدام حسين في العراق، بدأت سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) بإصدار الأمرين رقم 1 و2 اللذين أدّيا إلى تفكيك مؤسسات الدولة وإفراغ الوزارات من موظفيها بين عشية وضحاها. وتمّت إقالة المعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمهندسين والموظفين الحكوميين في المستويات الدنيا بشكل جماعي لمجرد انتمائهم الشكلي أو الاسمي إلى "حزب البعث"، بينما تم حل الجيش وقوات الأمن والمخابرات بالكامل. وما بدأ كمحاولة لتطهير النظام من رموز الاستبداد سرعان ما تحوّل إلى شللٍ مؤسسي وتفككٍ طائفيّ واسع. وفي ظل اقتصاد منهار ودولة مفككة، أسهمت سياسة الانتقال الإقصائية في تفاقم انعدام الأمن المجتمعي، مما أشعل نزاعاتٍ مسلّحة انتهت في نهاية المطاف إلى حربٍ أهلية ذات طابعٍ دولي بين عامَي 2006 و2008، تعددت فيها الجبهات والميليشيات شبه العسكرية.
تتأرجح سوريا اليوم على حافة منحدر مشابه، وهي تسعى جاهدة للتخلص من إرث "البعث". غير أن السعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية من دون ترسيخ ثقة كافية لدى الجمهور، أو من دون الاستجابة لأولويات الضحايا وبناء مؤسسات تتمتع بالمصداقية، يهدد بتقويض مبدأ المساءلة بدلاً من ترسيخه. ونتيجة لذلك، تفقد جهود الانتقال مشروعيتها الشعبية وتُصبح في نهاية المطاف غير فعالة. وفي حين يمثل العراق مثالاً تحذيرياً على انتقال فاشل، فإن اختلافات جوهرية عدة تفصل تجربته عن الظروف الراهنة في سوريا. فعلى عكس العراق في نيسان/أبريل 2003، لم يأتِ الانتقال في سوريا عقب غزو أجنبي مباشر، بل نتج عن انهيار داخلي للنظام، الأمر الذي أفرز هياكل سلطة أكثر تجزئة ومراكز نفوذ متنافسة. إضافةً إلى ذلك، فإن المجتمع السوري الذي شكّلته أكثر من عشرة أعوام من الحرب والنزوح يواجه دماراً اقتصادياً أوسع وأنماط حكم محلي أكثر تعقيداً مقارنة بالعراق ما بعد صدام. وهذه الفوارق البنيوية تزيد مخاطر تكرار التجربة العراقية في بيئة اجتماعية ومؤسسية أشد هشاشة وتقلباً.
من الإصلاح إلى التفتت
في كانون الأول/ديسمبر 2002، أصدرت مجموعة العمل المعنية بالمبادئ الديمقراطية تقريرها النهائي بعنوان "الانتقال إلى الديمقراطية في العراق "، حيث أوصت صراحة بتجنب تطبيق عملية اجتثاث البعثيين بشكل شامل، ودعت بدلاً من ذلك إلى اتباع نهج متوازن على غرار قوانين التطهير في أوروبا الوسطى. وأشارت المجموعة إلى أن هذه القوانين لم تستهدف اجتثاث جميع الشيوعيين السابقين، بل ركّزت على تحديد المسؤولين الرئيسيين المتورطين مباشرة في جرائم الماضي، وتبنّت آليات الاستئناف والمساءلة منذ مرحلة مبكرة. وأكد التقرير أن الخدمة المدنية والإدارة العامة والجيش في العراق، رغم تشوّهها بسبب عقود من الحكم البعثي، ظلت تحتفظ بمعرفة إدارية حيوية ينبغي صونها. كما دعا التقرير إلى تعريف أوسع للضحايا يشمل البعثيين العاديين الذين عانوا في ظل النظام، معترفاً بأن الانتقال في العراق ينبغي ألا يتم على حساب سبل العيش أو المصالحة الوطنية. غير أن سلطة الائتلاف المؤقتة تجاهلت هذه التوصيات.
وبدلاً من ذلك، أدت عمليات الفصل الجماعي - التي تعنى بتطهير جميع المناصب الحكومية من موظفي النظام السابق أو المرتبطين به - إلى ارتفاع معدلات البطالة، المرتفعة أصلاً، إلى ما بين 60 و75 %. كما عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة تعليق دفع رواتب كبار أعضاء "حزب البعث" بدلاً من استمالتهم. وهذا يتناقض بشدة مع الانتقال من الشيوعية في دولة تشيكوسلوفاكيا التى عُرضت على مسؤولي المخابرات السابقين "مميزات سخية" تفادياً للجمود المؤسسي والعزلة والتمرد. أما في العراق، فقد أصبحت الجماعات الساخطة التى قام النظام الجديد بإقصائها سريعاً، أرضاً خصبة لتجنيد المتمردين، حيث أدى الاستقطاب الأيديولوجي والخطاب الطائفي إلى تأجيج التوترات. وقد درست سلطة الائتلاف المؤقتة لاحقاً إعادة تشكيل الجيش بضم وحدات من الجيش القديم بسبب النقص العددي، لكن لم تُتخذ إجراءات لتعديل عملية اجتثاث البعثيين حتى عام 2006. وتحت ضغط الرمزية السياسية لسياسة التطهير، أُطلقت استراتيجية مصالحة مؤقتة وضعها رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل.
لا يمثل المثال العراقي حالة إخفاق في التنفيذ فحسب؛ بل هو تحذير من أن السياسات الانتقالية الخاطئة قد تقوض التماسك الوطني. وفي ظل تعثر المرحلة الانتقالية في سوريا وسط اندلاع موجات عنف طائفي جديدة، سيتعاظم الإغراء بتبني سياسات الإقالات الجماعية.
المسار الحالي لسوريا
أدى الفصل الجماعي في سوريا - حيث يعد القطاع العام هو أكبر جهة توظيف في البلاد - إلى زيادة معاناة بلد يعاني من هشاشة الاقتصاد الخاص ومعدل فقر يبلغ 90%. وفي كانون الثاني/ يناير، اندلعت احتجاجات في المدن الكبرى، بما في ذلك دمشق والسويداء وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس، حيث طالب العمال المفصولون بإعادة تعيينهم أو بالحصول على تفسير رسمي لفصلهم. وعلى الرغم من التراجع عن عدد قليل من حالات الفصل، وفق ما ورد، فإن عملية المراجعة الشاملة لهذه الإقالات لا تزال غير شفافة.
إلى جانب حجم عمليات التسريح، أثرت هذه السياسات بشكل غير متناسب على شرائح بعينها، ولا سيما أعضاء "حزب البعث" وعائلات القتلى من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية. وقد تضررت الطائفة العلوية، التي كانت تاريخياً مرتبطة بجهاز الأمن التابع للنظام، بشكل خاص، مما أثار مخاوف من معاقبة شرائح اجتماعية بأكملها بسبب ارتباطها بالنظام السابق. وبالنسبة إلى كثيرين، تفاقمت الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الفصل من العمل بسبب فقدان السكن الحمايات الاجتماعية التي كانت مرتبطة بتلك الوظائف.
خلال فترات الانتقال السياسي، تقع على عاتق السلطات المؤقتة مسؤولية التمهيد لحكومة دائمة منتخبة شعبياً، واتخاذ تدابير لبناء الثقة تعالج القلق الاجتماعي، وتعزز الحوار الوطني الحقيقي، وتُسهم في ردم الانقسامات العميقة. غير أن السلطات الانتقالية تُمارس سلطاتها بقدر ضئيل من الشفافية ومشاركة محدودة من المجتمع المدني، مما يعزز المخاوف بين الأقليات والسكان عموماً من أن النظام السياسي الناشئ سيكون إقصائي وغير تمثيلي. وحتى أيلول/سبتمبر 2025، اقتصر الحوار الوطني على مؤتمر واحد استمر يومًا واحدًا، عُقد في 25 شباط/فبراير 2025، وكان الاستبيان التحضيري له قد استثنى الدوائر الانتخابية في الحسكة والرقة.
أما المرسوم رقم 143 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع لإنشاء نظام انتخابي مؤقت للبرلمان السوري، فقد صُور كخطوة مفصلية نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس تنوع المجتمع السوري. لكنه أثار على الفور انتقادات واسعة من منظمات حقوقية سورية بارزة، جادلت بأن النظام الانتخابي المؤقت يرسخ هيمنة السلطة التنفيذية على بقية فروع الحكومة، ويستبعد قوى المعارضة والجماعات المهمشة، ويقيد الحريات السياسية، وينتهك التزامات سوريا الدستورية ومبادئ القانون الدولي. ويعكس ذلك مخاوف متزايدة من أن آليات العدالة الانتقالية قد تُوظف لتكريس السلطة بدلاً من وضع الأسس لمؤسسات تعددية ومستقلة حقاً.
وإجمالاً، فإن الاستبعاد الاقتصادي -الذي يشير إلى الفقدان الكبير للدخل والوظائف والحصول على المزايا الاجتماعية التي توفرها الدولة - والاستبعاد السياسي - من خلال الحرمان من الحقوق والأهلية للمشاركة في المؤسسات السياسية الجديدة - ينطويان على خطر ترسيخ الهرمية الطائفية والمحسوبية، مما يقوض في المحصلة شرعية العملية الانتقالية في سوريا.
مواجهة عقدة يهوذا
في العراق، كان اجتثاث البعثيين من مناصبهم محركاً رئيسياً لخطابات الولاء والخيانة وتحميل المسؤولية للمرتبطين بالنظام السابق. وقد وُصمت مجتمعات بأكملها بـ"يهوذا"، إما باعتبارها متواطئة في الاضطهاد في الماضي أو خائنة لـ"العراق الجديد". ومع ذلك، فإن الجهود الانتقالية التي تركز على الإقصاء الواسع لشرائح من المجتمع من النظام السياسي الناشئ لا تشكل تحدياً لوجستياً فحسب، بل هي خطيرة اجتماعياً أيضاً، لأنها تعمق الانقسامات في مجتمع ممزق أصلاً.
عندما أُطيح بصدام حسين، كان ما لا يقل عن 400 ألف عراقي يحملون عضويةٍ كاملة في "حزب البعث"، في حين تراوحت تقديرات عدد أعضاء الحزب بين 1.2 و2 مليون شخص. وقد استندت عمليات الفصل الجماعي إلى الإقصاء القائم على الرتبة، مما ترك مئات الآلاف من الأفراد بلا مصدر رزق في اقتصادٍ منهار، وكثيرٌ منهم كانوا مسلحين وجُردوا للتو من المكانة والدخل المرتبطين بالخدمة العسكرية أو الحكومية. كانت العضوية الكاملة في "حزب البعث" توفر في السابق امتيازات اقتصادية واسعة، شملت رواتب شهرية وفرص تفضيلية في التوظيف والسكن والتعليم، إضافة إلى السيطرة على موارد مهمة مثل بنوك البذور وبرامج التدريب التقني. وعندما زالت هذه المزايا فجأة، تفاقم الاستياء والشعور بانعدام الأمان، ولا سيما بين أفراد الأقلية السنية الذين تأثروا على نحو غير متناسب.
وقد ترسخت مكانة "حزب البعث" في المجتمع السوري منذ عام 1968 على الأقل، عندما تم توسيع العضوية الإلزامية في اتحاد شباب الثورة ليشمل جميع طلاب المدارس الإعدادية والثانوية. وفي كانون الاول/يناير 2011، بلغ عدد أعضاء الحزب 2.5 مليون عضو. وتم تعيين العلويين، لا سيما أبناء المناطق الريفية، بشكل استراتيجي في وحدات عسكرية نخبوية من أجل حماية النظام من محاولات الانقلاب. في الوقت نفسه، كانت العضوية في الحزب وسيلة حيوية للترقي بالنسبة إلى كثيرين من السنة. أما الذين شغلوا وظائف في القطاع العام، فكانوا أكثر ميلاً للبقاء في مناصبهم خلال سنوات الحرب بدافع الضرورة الاقتصادية، إذ إن الاستقالة قد تؤدي إلى إدراجهم في القوائم السوداء للوظائف الأخرى وتجعلهم أهدافاً للنظام. كان هذا هو حال طاهر الأمين، وهو موظف مالي سابق في المؤسسة العامة للمخابز التابعة للدولة. ويشكّل نموذج اجتثاث البعثيين في العراق أيضاً إنذاراً واضحاً لما قد تؤول إليه سياسة مماثلة في سوريا، إذ يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.
نحو نهج متوازن
في حين أن الفصل الجماعي من الوظائف يمثل آلية مغرية لتحقيق العدالة الانتقالية، إلا أنه ليس حلاً سحرياً. ونظراً للتشابك الكبير بين السكان المدنيين والعسكريين في سوريا داخل شبكات "حزب البعث"، فإن أي محاولة لتقييم الإدانة لدى جميع الأعضاء ستكون مرهقة إدارياً ومزعزعة للاستقرار السياسي. ويتجلى ذلك بوضوح في إرث النظام السابق القائم على التعيينات بالواسطة - مثل التوظيف عبر صلات القرابة بالجنود القتلى - إذ إن الإقالة الشاملة ستفرغ المؤسسات من محتواها دون معالجة قضية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال عهد البعث. فعلى سبيل المثال، أدت عمليات الفصل الجماعي في سوريا إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمين. وفي السياقات التي يكون فيها الفرز الفردي بطيئاً أو محدود الموارد، يمكن لعمليات الإقصاء المستهدف - التي تعطي الأولوية لإبعاد عدد محدود من الأفراد من الخدمة العامة بناءً على أدلة موثوقة تثبت المشاركة المباشرة أو المسؤولية القيادية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد أو خروقات القانون الإنساني الدولي - أن تسهم في سدّ فجوة الإفلات من العقاب. وتتجنب هذه الإجراءات الانتقائية عيوب الفصل الجماعي شريطة ألا تتحول إلى بديل عن المساءلة القضائية المستقبلية، وأن تكون عملية الفرز منفصلة بوضوح عن تحديد المسؤولية الجنائية.
تتطلب العمليات الانتقالية الناجحة تحقيق توازن دقيق بين العدالة والواقعية. وتظهر دروس التجربة العراقية الحاجة إلى عملية مرحلية وشفافة وشاملة تُقر بالأفعال الفردية غير المشروعة دون اللجوء إلى الاستبعاد الجماعي، وتضمن حماية برامج الفحص من التلاعب السياسي ومن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. وتقدم الهيئات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصيات قيّمة للإصلاح المؤسسي خلال فترات الانتقال. وتشمل التدابير المقترحة إنشاء هيئات مستقلة للرقابة والشكاوى، وتحديث الأطر القانونية، ومراجعة قواعد السلوك الأخلاقي، وإزالة الرموز المسيئة، وضمان رواتب وموارد كافية للحفاظ على الأداء المهني. ومن بين التوصيات البارزة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النظر في إشراك جهات دولية في الإشراف على عمليات الفرز. ويمكن أن يتراوح ذلك بين ترتيبات دولية بحتة أو آليات مختلطة تدعمها أمانات دولية، على أن يُراعى في كل منها الواقع السياسي المحلي لتفادي خلق انطباع بفرض إرادة أجنبية.
في المحصلة، قد تسهم ترتيبات تقاسم السلطة الفاعلة في استقرار المجتمعات المنقسمة، لكنها ليست مستدامة بحد ذاتها. ولضمان استدامة السياسات الانتقالية، يجب أن ترتكز على جهود المصالحة المحلية وأن تُدعم بمشاركة مدنية واسعة وحوار وطني شامل. وقد شهدت محافظة السويداء في سوريا، التي ظلت طويلاً بعيدة عن جبهات الحرب، اهتزازاً مؤخراً بفعل تصدع الاستقرار الطائفي. ويمثّل العنف هناك، إلى جانب المذابح التي شهدتها المدن الساحلية السورية في آذار/مارس، نموذجاً حياً على الانقسامات الاجتماعية والتشدد والتطرف الذي بات واضحاً اليوم. وتقف سوريا على مفترق طرق حاسم، إذ قد يحدد مسار تنفيذ العدالة الانتقالية ما إذا كانت البلاد ستتجه نحو المصالحة والاستقرار، أو نحو اندلاع حرب أهلية جديدة.